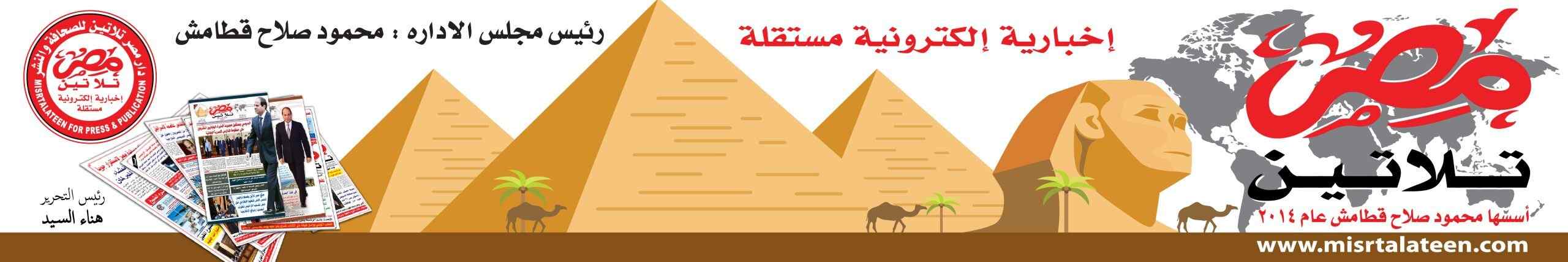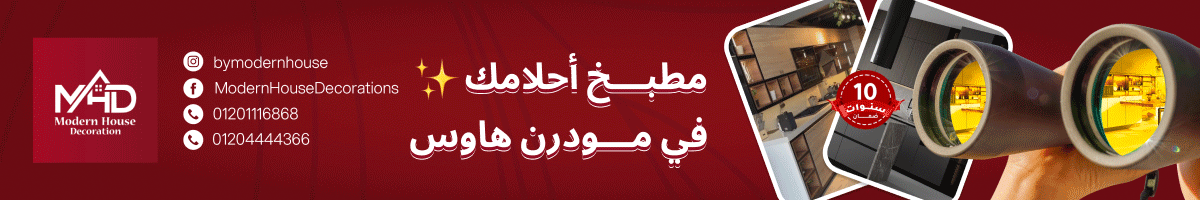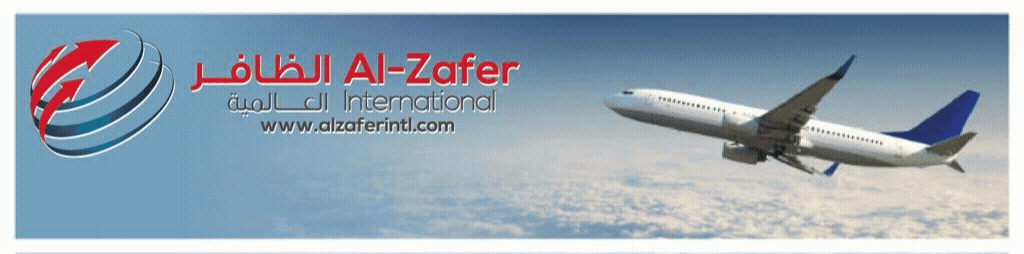عثمان بن عفان.. الخليفة يدافع عن نفسه فى الفتنة الكبرى ويرد الاتهامات
من الأحداث الكبرى التي لا يزال المسلمون يعانون منها إلى الآن الفتنة الكبرى، التي اندلعت في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وقد اندلعت فى الكوفة، لكنها لم تتوقف، يقول كتاب “عثمان بن عفان بين الخلافة والملك” لـ محمد حسين هيكل”:
أخذت الأمصار تحذو حذو الكوفة في التعبير عن استيائها من سياسة عثمان وسياسة عماله؛ فأقبل إلى المدينة في رجب سنة 35ﻫ وفد كبير من أهل العرب في مصر. وكانوا قد كاتبوا أشياعهم من أهل الأمصار أن يتوافدوا بالمدينة. وأظهروا أنهم يريدون أن يسألوا عثمان عن أشياء لتطير في الناس ولتحق عليه. فأرسل إليهم عثمان رجلين أحدهما من بني مخزوم والآخر من بني زهرة؛ ليقفا على سبب مجيئهم إلى المدينة. فلما التقيا بهم، قالوا لهما: نريد أن نذكر له (أي: لعثمان) أشياء قد زرعناها في قلوب الناس، ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أنا قررناه بها، فلم يخرج منها ولم يتب، ثم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط به، فنخلعه، فإن أبى قتلناه. ثم عاد الرجلان إلى عثمان وأخبراه بما سمعاه عن هؤلاء القوم، فضحك وقال: “اللهم سلم هؤلاء، فإنك إن لم تسلمهم شقوا”.
دعا عثمان المسلمين إلى صلاة جامعة، فأقبلوا جميعًا إلى مسجد المدينة، وفيهم صحابة الرسول ﷺ، فوقف عثمان فيهم خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، وأخبرهم خبر القوم، ثم قام الرجلان اللذان كان عثمان قد بعثهما للوقوف على حقيقة أغراض الوافدين إلى المدينة، فقالا لعثمان: “اقتلهم، فإن رسول الله ﷺ قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله، فاقتلوه.” فقال عثمان: “بل نعفو ونقيل ونبصرهم بجهدنا، ولا نحاد أحدًا حتى يركب حدًّا أو يبدي كفرًا، إن هؤلاء ذكروا أمورًا قد علموا منها مثل الذي علمتم إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونها ليوجبوها عليَّ عند من لا يعلم.” ثم أخذ عثمان يسوق ما اتهمه به هؤلاء الثوار ويدافع عن نفسه فيرد الاتهام عنه، فقال: “قالوا: أتم الصلاة في السفر وكانت لا تتم، ألا وإني قدمت بلدًا فيه أهلي، فأتممت لهذين الأمرين أو كذلك؟” فقالوا “اللهم نعم.” وانتقل عثمان إلى الاتهام الثاني، فقال: “وقالوا: وحميت حمى، وإني والله ما حميت حمى قبلي، والله ما حموا شيئًا لأحد ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينة، ثم لم يمنعوا من رعيته أحدًا، واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها؛ لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، ثم ما منعوا ولا نحوا منها أحدًا إلا من ساق درهمًا. وما لي من بعير غير راحلتين … وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعيرًا وشاة، فما لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي، أكذلك؟” فقال له الحاضرون: “اللهم نعم.” وطلبوا منه أن يقتل هؤلاء الثوار؛ فأبى عثمان ومضى يفند اتهاماتهم له؛ فقال: “وقالوا: إني رددت الحكم بن العاص — وقد سيره رسول الله ﷺ — والحكم مكي سيَّره رسول الله ﷺ من مكة إلى الطائف، ثم رده رسول الله ﷺ؛ فرسول الله سيره، ورسول الله رده … أكذلك؟” فأجاب الحاضرون: “اللهم نعم.” ثم قال عثمان: وقالوا: استعملت الأحداث، ولم أستعمل إلا مجتمعًا محتملًا مرضيًّا، وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنه. وهؤلاء أهل بلده، ولقد ولَّى مَن قبلي أحدث منهم، وقيل في ذلك لرسول الله ﷺ أشد مما قيل لي في استعماله أسامة. أكذلك؟” فأجاب الحاضرون في المسجد: نعم.
واصل عثمان تفنيد الاتهامات التي وجهت إليه فقال: «وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم. وأما إعطاؤهم، فإني أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيدة من صلب مالي أزمان رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي، فقال الملحدون ما قالوا، وإني والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلًا فيجوز ذلك لمن قاله، ولقد رددته عليهم وما قدم عليَّ إلا الأخماس، ولا يحل لي منها شيء.
استمع المسلمون الذين شهدوا هذا الاجتماع بالمسجد إلى دفاع عثمان عن سياسته، ورأوا أن يقتل عثمان كل من رفع لواء العصيان والثورة. غير أن عثمان آثر العفو عنهم ليعودوا إلى بلادهم. ولا غرو. فقد كان العفو والتسامح من أبرز صفات عثمان.
عاد أهل مصر إلى بلدهم، لكنهم ما لبثوا أن أقبلوا إلى المدينة في شوال من هذه السنة، وخرج في نفس الوقت جموع من الكوفة والبصرة، وأظهروا أنهم يريدون الحج حتى لا يتعرض أحد لهم، فلما جاءوا إلى المدينة رأوا عليًّا وطلحة والزبير، فعرض وفد مصر على عليٍّ بن أبي طالب أن يبايعوه فأبى وأمرهم بالانصراف عنه، وقدم وفد البصرة على طلحة فصدهم عنه. فعادوا يجرون أذيال الخيبة، وقدم وفد الكوفة على الزبير فخيب ظنهم.
تظاهرت وفود الأمصار الثائرة بالعودة إلى بلادهم حتى يفترق أهل المدينة، لكنهم ما لبثوا أن كروا راجعين، وفوجئ أهل المدينة بهؤلاء الثوار مكبرين في أرجاء بلدهم، وضربوا حصارًا حول دار عثمان وأعلنوا أن من كف يده فهو آمن، فلزم الناس بيوتهم.
أخذ كل من عليٍّ بن أبي طالب وطلحة والزبير يسأل الثوار عن سبب رجوعهم إلى المدينة، فأجاب أهل مصر عليًّا بقولهم: أخذنا مع بريد كتابًا بقتلنا. وقال البصريون والكوفيون مثل ذلك لطلحة والزبير، وأضافوا: نحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعًا. وقد روى الطبري قصة ذلك الكتاب فقال: إنما رد أهل مصر إلى عثمان بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير مصر أن يقتل بعضهم وأن يصلب بعضهم، فلما أتوا عثمان قالوا: هذا غلامك. قال: غلامي انطلق بغير علمي. قالوا: جملك. قال: أخذه من الدار بغير أمري، قالوا: خاتمك. قال: نقش عليه.
لما تحقق عثمان من خطورة الحالة بالمدينة ورأى نفسه عاجزًا عن إخماد حركة الثوار، بعث بكتب إلى الأمصار يطلب فيه المدد والنجدة. وجاء في هذه الكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن الله — عز وجل — بعث محمدًا بشيرًا، فبلغ عن الله ما أمره به، ثم مضى وقد قضى الذي عليه، وخلف فينا كتابًا فيه حلاله وحرامه وبيان الأمور التي قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا، فكان الخليفة أبو بكر — رضي الله عنه — وعمر رضي الله عنه، ثم أدخلت في الشورى من غير علم ولا مسألة ولا ملأ من الأمة، ثم أجمع أهل الشورى عن ملأ منهم، ومن الناس على غير طلب مني ولا محبة فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون تابعًا غير مستتبع، متبعًا غير مبتدع، مقتديًا غير متكلف. فلما انتهت الأمور وانتكث الشر بأهله بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضي إلا إمضاء الكتاب، فطلبوا أمرًا وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر، فعابوا عليَّ أشياء مما كانوا يرضون وأشياء عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها، فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم منذ سنتين، وأنا أرى وأسمع، فازدادوا على الله — عز وجل — جرأة حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وأرض الهجرة، وثابت إليهم الأعراب، فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزانا بأحد إلا ما يظهرون، فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق”.